المؤمنون مع محمّدٍ(ص): إخوةٌ، راحمون، عابدون، متآزِرون
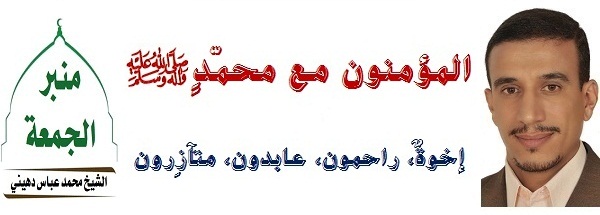
(الجمعة 1 / 1 / 2015م)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمّدٍ، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وأصحابه المنتَجَبين.
في البداية نُبارك لجميعِ المؤمنين والمؤمنات، بل للبشريّة والإنسانيّة جَمْعاء، ولادةَ النبيِّ الأعظم، والرسول الأكرم، نبيّ الرَّحْمة والهُدى، ومنقذ الأمّة من الضلالة والرَّدى، محمد بن عبد الله(ص)، الهاشميّ القُرَشيّ المَكِّيّ المَدَنيّ، خاتم الأنبياء والمرسلين.
تمهيد
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: 10).
إنّها الأُخُوَّة بين المؤمنين، المؤثِّر المباشر على تركيبة المجتمع الإسلامي، وعلى العلاقة بين أفراده.
هذه الأخوّة الروحيّة التي تُلزم الإنسان المؤمن، تجاه نظيره المؤمن، بالكثير من الحقوق، كحقّ الاحترام، والنَّصيحة، والمَعُونة، و…
هذه الأُخُوَّة الروحيّة هي الأخوّة التي اعتبرها الله سبحانه وتعالى وسيلةً للترابط والمَوَدّة والرَّحْمة.
فأخوّة النسب، وغيرها من العلاقات النسبيّة، كالبُنُوّة، لا تمثِّل عند الله عزَّ وجلَّ أيَّ قيمةٍ ما لم تكن مقارِنةً لهذه الأخوّة. وقد حدَّثنا الله سبحانه وتعالى عن نبيِّه نوح(ع)، الذي وعده الله بإنقاذ أهله من الغَرَق، بقوله: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ (هود: 40)، أنّه قال، عندما رأى وَلَدَه يغرق: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ (هود: 45)، وجاءه الجواب سريعاً وواضحاً: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ (هود: 46).
وقد أراد الله لهذه الأخوّة أن تولِّد بين المؤمنين نوعاً من المحبّة والمودّة والأُلْفة، تمنع أحدهم عن الآخر. وكيف لا، وهي علاقةٌ أساسُ نشأتها من الله سبحانه وتعالى؟! نعم، أرادها أن تمنع بينهم أيَّ ضغينةٍ، وأيَّ حِقْدٍ، وأيَّ عداءٍ، حتَّى جاء في الحديث: «إذا قال المؤمنُ للمؤمنِ أنتَ عدوِّي كفر أحدُهما». لماذا؟ لأنّ الله يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، بما تمثِّله (الأخوّة) من محبّة ومودّة، وهو يقول لأخيه المؤمن: «أنتَ عدوّي»، بما تحمله لفظة (العدوّ) من معاني البُغْض والشنآن. فاللهُ يقول، وهو يقول، فهل يكون مسلماً؟!
المؤامرة الكبرى على النبيّ(ص)
لطالما عرفوه ونعتوه بـ «الصادق الأمين»، ورضُوا به حَكَماً ومُشيراً.
وما إنْ بُعث بالرسالة، وجاءهم بالهدى والحقّ، ﴿دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾ (الأنعام: 161)، حتّى اتَّهمُوه بأنّه «ساحرٌ»، و«مجنونٌ»، و«كاذبٌ»، و«كاهنٌ»، وأخذوا يؤذونه، كلَّما سنحت لهم الفرصة، حتّى قال(ص): «ما أُوذي نبيٌّ مثل ما أُوذيتُ».
ورحل المحامي والكفيل، ورحل أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، والدعوةُ الإسلاميّة قد ظهرَتْ إلى الوجود، وأخذَتْ تطرق كلَّ أُذُن، وأحسَّتْ (قريش) بالخطر الكبير يحدِّق بمصالحها، ويهدِّد زعامتها، فقرَّرتْ الخلاص من محمّدٍ(ص)، وعزمَتْ على أن تضع حدّاً لهذا الانتشار الإسلامي، ولكنْ كيف السبيلُ إلى ذلك؟
يحدِّثنا الله عن ذلك الانقلاب الكبير، وتلك المؤامرة والمكيدة العظيمة، بقوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (الأنفال: 30)، أي ليحبسوك أو يقتلوك أو ينفوك.
الهجرة إلى الله
واضطرَّ(ص) ـ كمَنْ سبقه من المسلمين ـ للهجرة من مكّة، مهوى الفؤاد وحَبّة القلب، فودَّعها وداع مَنْ عزَّ فراقُها عليه، وهو القائل: «لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ أَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيْهِ، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ».
وكانت هجرةً قَسْريّة إلى «يثرب» فحلَّ بها، مبارِكاً، ومنيراً، فأصبحَتْ «المدينةَ المنوَّرة» بنور الإسلام، ونور النبيِّ الأكرم محمد(ص).
إذاً كانت مكّةُ أرضاً لتحضير القاعدة الشعبيّة؛ للنهوض بعد ذلك بالدولة الإسلامية في المدينة المنوَّرة.
ومن خلال هذا التقسيم: مكّةُ تحضيرٌ للدولة؛ ويثربُ إنشاءٌ للدولة، ووضعُ نظامٍ لها، نعرف أهمّيّة الخطوات التي اتَّخذها رسولُ الله(ص) في المدينة المنوّرة.
خطواتٌ في طريق الإسلام
1ـ وأوّلُ هذه الخطوات بناءُ المسجد؛ ليكون ملتقى الناس، ومكانَ اجتماعهم؛ وللتركيز على أهمّية المسجد في حياة الإنسان، العباديّة والثقافيّة والاجتماعيّة، فهو مكانُ الصلاة والاعتكاف، وهو مكانُ الدرس والمناظرة والحوار، وهو ملتقى المؤمنين، يتعرَّفون فيه على مشاكل بعضهم، ويتشاورون فيه في سُبُل حلِّها، وتنظيم واقعهم. فأيُّ مكانةٍ للمسجد هي هذه المكانة؟!
ومن هنا كان تركيز الإسلام على الحضور في المساجد، فكان حديثُه(ص): «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد»، وكانت الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ﴾ (التوبة: 18).
2ـ وأمّا خطوته الثانية فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حيث طلب من كلِّ أنصاريٍّ أن يتَّخذ له أخاً من المهاجرين، يقاسمه مالَه، ودارَه، وأرضَه؛ لتتعمَّق بينهما روح الأخوّة الدينيّة، وتشتدَّ خيوط التعاون والمَحَبّة والرَّحْمة. وبهذا صار الذين معه أشدّاء على الكُفّار، رُحَماء بينهم.
أتباع النبيّ(ص): أشدّاء على الكفّار، رحماء بينهم
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾ (الفتح: 29).
بهذا الوَصْف (رسولُ الله) نَعَتَ اللهُ جلَّ جلاله عبدَه وحبيبَه محمّداً، فهذه هي الصفة الشخصيّة التي ينبغي للمسلم أن يهتمَّ بها، ويلتفت إليها، بعيداً عن أوصاف الجَسَد، أو سلسلة النَّسَب، أو غير ذلك.
فمحمدُ بن عبد الله(ص) هو رسولُ الله الخاتم، الذي لا نبيَّ بعده، وشريعتُه هي الشريعةُ النهائيّة الصالحة لكلِّ زمانٍ ومكان إلى يوم القيامة.
وكما كان لكلِّ نبيٍّ أتباعُه ومريدوه، وكذلك خصومُه وأعداؤه، فقد كان لنبيِّ الإسلام أتباعٌ ومريدون كُثُرٌ، أو هكذا يدَّعون. وقد بيَّن الله في هذه الآية صفاتِ أتباع هذا النبيِّ العظيم، بما يوحي أنّ مَنْ لا يستجمع هذه الصفات فليس من أتباعه، ولو ادَّعى ذلك قَوْلاً ظاهراً.
أتباعُ النبيّ الأكرم محمّدٍ هم الأشدّاءُ على الكفّار، الذين لا يخافونهم، ولا يجبُنون عن مواجهتهم، ولا يُحابونهم، ولا يتملَّقون لهم، وإنَّما هو موقفٌ حازم، لا ضَعْفَ فيه: آمِنوا بالله تكونوا إخوةً لنا في الدِّين، فإنْ كفَرْتُم واعتدَيْتُم، وكِدْتُم للإسلام والمسلمين، فهو القتالُ والبأسُ الشديد.
أشدّاء على الكفّار، لا حِقْداً، ولا بُغْضاً؛ بل لأجل هدايتهم. وذلك واقعٌ مفروضٌ. فالمسلمون لم يشهروا سَيْفاً إلاّ في وجه مَنْ قاتلهم، وناصبهم العَدَاوة والبَغْضاء، فكانت بدرٌ، وأُحُد، والأحزاب، وخيبر، وحُنَيْن، وتبوك، وغيرها.
وهم الرحماءُ فيما بينهم، فلا يحمل أحدُهم على أخيه المسلم حِقْداً أو غِلاًّ، ولا يحسده، ولا يغتابه، ولا يتجسَّس عليه، ولا يكيد له, وإنَّما هم إِخْوةٌ رحماء، يعيشون المَحَبَّة والرَّأْفة والرَّحْمة.
رحماءُ بينهم؛ لأنّه لا حياة بلا رَحْمةٍ، وبلا مَحَبَّةٍ، وبلا تعاونٍ. فكيف يبني رسول الله(ص) دولةً إسلاميّة دون توفير شروط الحياة لها؟! لهذا كانت تلك المؤاخاة.
فما أحوجنا إليها اليوم، ونحن في حَمْأة الصراع، ولهيب النِّزاع، يقتل بعضُنا بعضاً، ويسبّ بعضُنا بعضاً، باسم الدِّين والإيمان، والدِّين والإيمان من كلِّ ذلك بَراءٌ.
عابدون طائعون، في طريق النصر الإلهيّ
وهم الرُّكَّعُ السجود لله سبحانه وتعالى، تعظيماً لشأنه، واعترافاً بقَدْره، وشُكْراً لنَعْمائه، وطَلَباً لمَرْضاته وفضله.
ولهؤلاء المسلمين ـ أتباع النبيّ الأكرم ـ سيماءٌ وسلوكٌ معيَّن، يُعرَفون به بين الناس، فهم الصادقون، والأُمَناء، والمُوفون بعَهْدهم، والذين تظهر آثار العبادة والطاعة والمناجاة لله في وجوههم، فترى فيها أثر السجود بارزاً، كشاهِد صِدْقٍ على أنَّهم يقومون بتكاليفهم على أتمِّ وجهٍ.
هذا هو مَثَلهم في التوراة، وهو الكتابُ السماويّ المقدَّس الذي أُنزل على نبيِّ الله وكليمه موسى(ع).
وأمّا مَثَلهم في الإنجيل ـ وهو الكتاب السماويّ المقدَّس الذي أُنزل على روح الله وكلمته عيسى(ع) ـ فهو أنّهم يعيشون التكافُل والمودَّة فيما بينهم، فمَثَلهم كزَرْعٍ أفرخ من جوانبه، فاستكثر، واستوى الجميعُ بمقدارٍ واحد، ما يعني وفرةً في النِّتاج الزراعيّ، وبذلك يفرح الزُّرّاع.
وتلك إشارةٌ إلى قوّة النبيّ(ص) بأصحابه وأتباعه، حتَّى لم يعُدْ للمشركين بهم طاقةٌ.
وذلك هو الوعد الإلهي للمؤمنين حقّاً، العاملين صِدْقاً، بالمَغْفرة والمَثُوبة، والتمكين في الأرض، والغَلَبة على كلِّ كافرٍ لا يؤمن بيوم الحساب.
ربَّنا آتِنا ما وَعَدْتَنا على رُسُلِكَ، ولا تُخْزِنا يوم القيامة، إنَّكَ لا تُخْلِف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالَمين.



