الحسن بن عليّ المجتبى(ع)، تاريخٌ مجيد لن يطاله التشويه
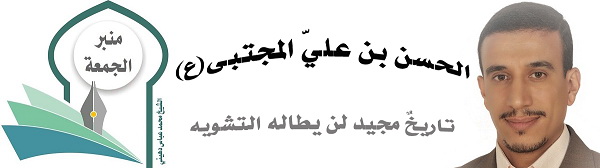
(الجمعة 27 / 10 / 2017م)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمّدٍ، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وأصحابه المنتَجَبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
نلتقي في السابع من شهر صفر الخير بذكرى شهادة سبط رسول الله(ص) وريحانته، ثاني أئمّة أهل البيت(عم)، الحسن بن عليّ المجتبى(ع)، ذاك الإمام المظلوم من بعض شيعته كما من عدوّه. فتعالَوْا نتعرَّف على بعض جوانب حياته وصفاته وأسرار مظلوميّته:
الحسن بن عليّ المجتبى(ع)، بعضٌ من أخلاقه وصفاته
أمّا نسبه فإنّه(ع) أغنى عن التعريف؛ لأنه ابن رسول الله(ص)، وذلك يجعله أشهر من نارٍ على عَلَم.
وأمّا صفاته فقد كان(ع) أحلم أهل عصره وأهيبهم وأزهدهم وأعبدهم.
فقد التقى في المدينة المنوَّرة رجلاً شاميّاً ممَّنْ عبّأهم معاوية بغضاً وحقداً وكرهاً لأمير المؤمنين عليٍّ وأهل بيته(ع)، فجعل الشاميّ يسبّه، والإمام ملتفتٌ عنه، كأنّه لا يسمع ما يقول، فواجهه الرجل، وقال: إيّاك أعني، فقال(ع): وعنك أعرض.
وكان(ع) إذا حجّ بيت الله الحرام حجَّ ماشياً، وربما مشى حافياً؛ تواضعاً لله سبحانه وتعالى، وكان الناس ينزلون عن مراكبهم؛ استحياءً منه، حتَّى سلك طريقاً آخر؛ ليتمكّن الناس من الركوب.
وكان(ع) يعيش الخوفَ من الله سبحانه وتعالى ـ وهو المعصوم ـ كأشدّ ما يكون الخوف، فكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممرّ على الصراط بكى، وإذا ذكر العَرْض على الله تعالى ذكرُه شهق شهقةً يُغشى عليه منها، وإذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه عزَّ وجلَّ.
وكان إذا توضّأ ارتعدت مفاصله، واصفرّ لونه، فقيل له في ذلك، فقال: حقٌّ على كلٍّ مَنْ وقف بين يدي ربِّ العرش أن يصفرّ لونه، وترتعد مفاصله.
وكان إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه، وهو يقول: إلهي ضيفُك ببابك، يا محسنُ، قد أتاك المسيء، فتجاوَزْ عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك، يا كريم.
وقد حيَّتْه جاريةٌ له(ع) بطاقة رَيْحان، فقال لها: أنتِ حرّةٌ لوجه الله، فقيل له في ذلك، فقال: أدَّبنا الله تعالى، فقال (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)، وكان أحسن منها اعتاقها.
وما هذا إلاّ غيضٌ من فيض من صفاته وأخلاقه سلام الله عليه.
بعضٌ من حِكَمه ومواعظه
أمّا علمه فقد كان(ع) يعمل كلّ ما في وسعه لتعليم الناس وإرشادهم ووعظهم.
وقد ورد عنه(ع) قوله: هلاك المرء في ثلاث: الكبر؛ والحرص؛ والحسد. فالكبر هلاك الدين، وبه لُعن إبليس؛ والحرص عدوّ النفس، وبه أُخرج آدم من الجنّة؛ والحسد رائد السوء، ومنه قتل قابيل هابيل.
وروي عنه أيضاً أنّه قال: لا أدب لمَنْ لا عقل له، ولا مروءة لمَنْ لا همّة له، ولا حياء لمَنْ لا دين له. ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل. وبالعقل تدرك الداران جميعاً، ومَنْ حُرم من العقل حُرمهما جميعاً.
وقال(ع): يا بن آدم، عُفَّ عن محارم الله تكُنْ عابداً، وارْضَ بما قسم الله سبحانه تكُنْ غنياً، وأحسِنْ جوار مَنْ جاورك تكُنْ مسلماً، وصاحِبْ الناس بمثل ما تحبّ أن يصاحبوك به تكُنْ عدلاً.
وقد قال(ع)، في ما روي عنه، شعراً يظهر تفاهة هذه الدنيا وحطامها في حياة الإنسان، الذي يركض ويركض لتحصيل الأكثر فالأكثر منها:
|
لكسرةٌ من خسيس الخبز تُشبعني |
وشربةٌ من قراح الماء تكفيني |
|
|
وطمرةٌ من رقيق الثوب تسترني |
حيّاً وإنْ مِتُّ تكفيني لتكفيني |
وقال رجلٌ للحسن بن عليّ(ع): إنّي من شيعتكم، فقال الحسن(ع): يا عبد الله، إنْ كنتَ لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقت، وإنْ كنتَ بخلاف ذلك فلا تزِدْ في ذنوبك بدعواك مرتبةً شريفةً لستَ من أهلها.
وأوصى(ع) رجلاً من مواليه ومحبّيه فقال: استعدَّ لسفرك، وحصِّل زادك قبل حلول أجلك، واعلَمْ أنّه تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل همَّ يومك الذي لم يأتِ على يومك الذي أنتَ فيه، واعلَمْ أنّك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك إلاّ كنتَ فيه خازناً لغيرك، واعلَمْ أنّ في حلالها حساباً، وفي حرامها عقاباً، وفي الشبهات عتاباً، فأنزِلْ الدنيا بمنزلة الميتة، خُذْ منها ما يكفيك، فإنْ كان ذلك حلالاً كنتَ قد زهدتَ فيها، وإنْ كان حراماً لم يكن فيه وزرٌ، فأخذتَ كما أخذتَ من الميتة، وإنْ كان العتاب فإنّ العتاب يسيرٌ. واعمَلْ لدنياك كأنّك تعيش أبداً، واعمَلْ لآخرتك كأنّك تموت غداً. وإذا أردتَ عزّاً بلا عشيرة، وهيبةً بلا سلطان، فاخرُجْ من ذلِّ معصية الله إلى عزِّ طاعة الله عزَّ وجلَّ. وإذا نازعَتْك إلى صحبة الرجال حاجةٌ فاصحَبْ مَنْ إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردتَ منه معونة أعانك، وإنْ قلتَ صدَّق قولك، وإنْ صُلْتَ شدَّ صولك، وإنْ مددت يدك بفضلٍ مدَّها، وإنْ بدت منك ثلمةٌ سدَّها، وإنْ رأى منك حسنةً عدَّها، وإنْ سألتَه أعطاك، وإنْ سكتَّ عنه ابتدأك، وإنْ نزلت بك إحدى الملمّات واساك، مَنْ لا يأتيك منه البوائق، ولا يختلف عليك منه الطرائق، ولا يخذلك عند الحقائق، وإنْ تنازعتما منفساً آثرك.
هذا هو الحسن بن عليّ (ع)، والذي يجهله ـ وللأسف ـ الكثيرون من شيعته؛ تقصيراً في حقِّه، ويجهله الآخرون؛ نتيجة تلك الشائعات والدعايات التي قام بها بنو أميّة ضدّه(ع).
صلح الحسن(ع) لا يختلف عن ثورة الحسين(ع)
يقولون: إنّه كان محبّاً للسلامة، كارهاً للحرب، ولإراقة الدماء، فصالح معاوية، ومن هنا كان يمرُّ به أحدُهم، فيقول له: السلام عليك يا مذلَّ المؤمنين، أو كما نسمع في يومنا هذا بعض الذين لم يفهموا الحسن(ع) جيّداً يقول: الحمد لله الذي جعلنا حسنيّين، ولم يجعلنا حسينيّين، وكأنّ الحسين(ع) يختلف عن الحسن(ع)، فهل هذا صحيحٌ؟
أوّلاً: إنّ هذا كلامٌ لا يوافقهم عليه التاريخ، فضلاً عن عقيدتنا الإسلاميّة، التي تقول بكمال أهل البيت(ع) وعصمتهم. ولطالما قالها رسولُ الله(ص): الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة، والحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا.
ثانياً: الحقيقة أنّ عكس ما قالوا هو الصحيح. فالحسن(ع) لم يكن كارهاً للحرب ومحبّاً للسلامة، وإلاّ فلماذا جهَّز جيشاً سار به لقتال معاوية، وقد سار مسافةً من الطريق، ولكنْ ما حصل بعد ذلك جعله يعدل عن رأيه، تماماً كما هي حال أمير المؤمنين عليّ(ع) في صفين، فجيش الحسن(ع) انقسم، بل نستطيع القول: إنّه لم يبقَ معه إلاّ خواصّ أصحابه، بعد أن أغرى معاوية قياديّي الجيش بالمال، فتركوا الحسن(ع)، وذهبوا إليه.
وليس هذا فحسب، بل إنّ بعض الذين تركوه حاولوا طعنه، فأصيب في فخذه، فعالجها حتّى برئت، فكان في تلك الفترة لا يخرج إلى الصلاة إلاّ متدرِّعاً؛ خوف الاغتيال.
أمام هذا الواقع وجد الحسن(ع) أنّه لا إمكانية لإزالة معاوية من الحكم، وأنه لا بدّ من التعايش معه، فليكن لنا بعض المطالب، بدلاً من أن نكون خارج الحساب نهائياً، فوافق على الصلح، الذي طلبه معاوية، ولكنّه شرط عليه شروطاً، منها: أن لا يُسبَّ عليٌّ(ع) على المنابر؛ ومنها: أن لا يتعرَّض معاوية وأتباعه لشيعة عليٍّ(ع) بالسوء؛ ومنها: أن لا يعيِّن معاوية الخليفة من بعده. وهذه كلُّها شروطٌ مربحة لو التزم بها معاوية.
ثالثاً: لولا مواقف الحسن(ع)، سواء في صلحه أو وعظه وإرشاداته، لاستطاع معاوية أن يسيطر على عقول الناس وإرادتهم، ولأفهمهم أنّ الإسلام هو ما يقوم به هو وأولاده من بعده، وهكذا يكون الحسن(ع)؛ بقبوله الصلح، قد قطع عليه طريق إفناء الشيعة وأتباع الحقّ، بل إفناء المسلمين، فها هو يقول لأحدهم لمّا عاتبه على الصلح: إنّي خشيتُ أن يُجتثّ المسلمون عن وجه الأرض، فأردتُ أن يكون للدين ناعي، ويقول لآخر، حين سأله عن علّة الصلح: ولولا ما أتيتُ لما تُرك من شيعتنا على وجه الأرض أحدٌ إلاّ قُتل. إذاً الحسن(ع) صالح معاوية؛ حفظاً للدماء، ولم يتنازل، بل بقي على موقفه الرافض للظلم كلّه، وللانحراف كلّه، وتفرَّغ لوعظ الناس وإرشادهم؛ ليمكِّن في نفوسهم تعاليم الإسلام، وليعرِّفهم حقيقة أهل البيت(ع)، وأنّهم أوّلُ المسلمين، والسابقون إلى الإسلام والإيمان واتِّباع شريعة الله، وأنّهم أولى الناس بخلافة رسول الله(ص).
رابعاً: إنّ الحسين(ع) وافق مع أخيه الحسن(ع) على عقد الصلح، ولم يكن له رأيٌ مختلفٌ أبداً. وهكذا كان الحسن(ع) حاضراً في ثورة عاشوراء من خلال ولده القاسم، ووصيّته له بالقتال إلى جانب عمّه الحسين(ع).
وخيرُ دليل على صوابيّة موقف الحسن(ع)، وكون (الصلح) لصالح المؤمنين، أنّ معاوية نقضه بسرعة، فقد اكتشف أنّ شروط الصلح قيَّدته ومنعته من تحقيق أهدافه، فخطب خطبته التي يقول فيها: إنّي والله ما قاتلتكم لتصلّوا، ولا لتصوموا، ولا لتحجّوا، ولا لتزكّوا، إنّكم لتفعلون ذلك، ولكنّي قاتلتكم لأتأمَّر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك، وأنتم له كارهون. ألا وإنّي كنتُ منَّيتُ الحسن وأعطيتُه أشياء، وجميعُها تحت قدميّ، لا أفي بشيءٍ منها له. وبهذا خرج من الصلح، وانطلق يخطِّط للقضاء نهائيّاً على الحسن(ع)، فدبَّر أمر اغتياله بالسمّ، الذي دسّته له زوجته جعدة بنت الأشعث، بإغراءٍ من معاوية.
تُهْمةٌ باطلة
ويتّهمون الحسن(ع) بأنه كان مزواجاً مطلاقاً، يتزوَّج النساء ويطلِّقهنّ، حتّى تضجَّر من ذلك أبوه عليٌّ(ع)؛ حياءً من أهلهنّ إذا طلّقهنّ، وكان يقول ـ كما يزعمون ـ: إنّ حسناً مطلاقٌ؛ فلا تزوِّجوه.
وهذا أيضاً ظاهرُ البطلان والزيف، فهم يحاولون تصوير الحسن(ع) رجلاً لا همّ له في هذه الدنيا سوى إشباع شهواته، تاركاً الجهاد، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكنّهم لم يحسنوا حتّى في كذبهم وافترائهم؛ فإنّ مَنْ ذكر أنّه كان مزواجاً مطلاقاً، وأنّه قد تزوَّج بسبعين امرأةً، لم يستطع أن يحصي له أكثر من عشر نساء لا غير، عدَّهنّ بأسمائهنّ. وعشر نساء في ذلك الزمن أمرٌ متعارَف، لا يستدعي استنكاراً وتشهيراً. كيف وقد توفّي رسول الله(ص) عن تسعةٍ من النساء. فضلاً عن أنّ كثيراً من النساء كنَّ يرغبنَ ويطلبنَ الزواج من الحسن والحسين(ع)؛ طمعاً في قرابة رسول الله(ص).
ولكنَّها ألسنٌ وأقلامٌ باعَتْ نفسها للشيطان، المتمثِّل في الخليفة الأمويّ، يغدق عليهم المال؛ في سبيل تشويه صورة أهل البيت(ع)، ومَنْ يشوِّه أكثر يُعطَ أكثر.
مع الحسن والحسين(عما)، قادةً وقدوة
ولولا مواقف الحسن(ع)، سواء في صلحه أو وعظه وإرشاداته، لاستطاع معاوية أن يسيطر على عقول الناس وإرادتهم، ولأفهمهم أن الإسلام هو ما يقوم به هو وأولاده من بعده. وهكذا يكون الحسن(ع)؛ بقبوله الصلح، قد قطع عليه طريق إفناء الشيعة وأتباع الحقّ، بل إفناء المسلمين. فها هو يقول لأحدهم لمّا عاتبه على الصلح: إنّي خشيتُ أن يُجتثّ المسلمون عن وجه الأرض، فأردتُ أن يكون للدين ناعي. ويقول لآخر، حين سأله عن علّة الصلح: ولولا ما أتيتُ لما تُرك من شيعتنا على وجه الأرض أحدٌ إلاّ قُتل. فقد صالح(ع)؛ حفظاً للدماء، ولم يتنازل أبداً، بل بقي على موقفه الرافض للظلم كلِّه، وللانحراف كلِّه، وتفرَّغ لوعظ الناس وإرشادهم؛ ليمكِّن في نفوسهم تعاليم الإسلام؛ وليعرِّفهم حقيقة أهل البيت(ع)، وأنّهم أوَّلُ المسلمين، والسابقون إلى الإسلام والإيمان واتِّباع شريعة الله، وأنهم أَوْلى الناس بخلافة رسول الله(ص).
فهل نكون الحسنيِّين، حين تقتضي الظروفُ ذلك، كما حاولنا ونحاول أن نكون الحسينيِّين، في الثورة المسلَّحة ضدّ الظالمين؟ بهذا وحده، لا بغيره، تكون النجاة في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.



